اقتصاد
حاكمية المصرف المركزي: مواصفات ورؤيا قبل الأسماء… أي سياسة نقدية للمرشحين؟

تُبيّن الأدبيات الإقتصادية مواصفات محددة لحاكمية المصارف المركزية التي تصبّ في إطار صاحب الاختصاص والرؤيا الواضحة للسياسة النقدية (وليس فقط النظرة القانونية والمالية والادارية…)، والتي تحتّم التعمّق بها وبدوره من خلالها قبل أي بحث في الأسماء… علماً أنه في مفاصل مصيرية في مسار البلدان الصغيرة، مثل لبنان، وعند حصول تسويات تاريخية كبرى كمِثل التي حصلت لحظة الخروج من الحرب اللبنانية وبدء إعادة الإعمار قد تطغى على قيادة المشروع الاقتصادي شخصية استثنائية مواكبة دولياً، مثل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لإحداث التغيير الكبير في النقد ونظام سعر الصرف… أما في غياب حالة كهذه وبعد سقوط مُدوٍ للاستقرار النقدي وهروب مُتماد من العملة الوطنية في اتجاه دولرة تلامِس 90 % من الإقتصاد، فلا بد من التركيز على مواصفات حاكمية المصرف المركزي والسياسة النقدية المطلوبة والمُغطاة دولياً قبل البحث في أسماء من سيتولّاها…
تصدّر مواصفات حاكمية المصارف المركزية في الأدبيات الاقتصادية وحصيلة الدراسات التطبيقية ما يُعرَف ب”عقد روغوف” Contrat de Rogoff الذي يحدد شخصية “الحاكم المحافظ” للمصرف المركزي مشددا على أن يكون لديه الأولوية لاستقرار قيمة العملة والقدرة الشرائية بمواجهة خطر التضخّم وذلك بدرجة أعلى مما يتوقّعه متوسّط العملاء الاقتصاديين.. وذلك يكون بشكل أساسي من خلال التمكّن من الدفاع عن استقلالية السياسة النقدية لاسيما إزاء ضغوط السلطات السياسية لتمويل العجوزات المالية العامة وانغماس الجهاز المصرفي في تمويل الدين العام وطباعة النقد و”سياسات الدعم” وشراء الوقت عبر سايسات نقدية غير تقليدية (مثل الهندسات المالية وغيرها…) خاصة قبيل الفترات الانتخابية لإرضاء الجمهور ظرفيا وتدفيعه ثمن التضخّم وانهيار سعر العملة على المدى البعيد…
هل من د. إدمون نعيم اليوم يتمترس بمواد استقلالية المصرف المركزي في قانون النقد والتسليف ويرفض الانصياع حتى لمنطق القوة وكافة انواع الضغوط في عز فترة الحرب والفلتان الأمني رفضا لطباعة متواصلة للعملة ورفضا للمس باحتياطي الذهب وودائع الناس ورفضا لطباعة عملتين أثناء بيروت الى عاصمتين؟! أصدرت السلطة السياسية أمرا بإحضاره بالقوة ، وسحبه من قدميه من مكتبه في الطابق السادس إلى الطابق الارضي ، لكنه تمكن من الإفلات بمساعدة “حسين” الحارس الأمين لمصرف لبلن آنذاك؟ هل من حاكم مثيل للدكتور نعيم يدخل مصرف لبنان حاملا كتبه ويخرج منه لا يملك سوى مكتبته؟
هل من “حاكم ذهبي” اليوم مثل الياس سركيس متنزّه ورؤيوي الذي عمد منذ لحظة وصوله الى حاكمية مصرف لبنان في العام 1967 الى انطلاق رحلة شراء احتياطي الذهب وتخزينه، واشترى خمسة ملايين أونصة لحساب الخزانة حين كان حاكماً لمصرف لبنان؟!!
هل من حاكم يلتزم بالمادة 13 التي تنص على أن “المصرف” شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي؟ ويجرأ على الدفاع عن المادة 91 التي تشدّد على أنه في ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى، اذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي، تحيط حاكم المصرف علما بذلك. يدرس المصرف مع الحكومة امكانية استبدال مساعدته بوسائل اخرى، كاصدار قرض داخلي او عقد قرض خارجي او اجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الاخرى او ايجاد موارد ضرائب جديدة…وفقط في الحالة التي يثبت فيها انه لا يوجد أي حل اخر, واذا ما اصرت الحكومة ، على طلبها، يمكن المصرف المركزي ان يمنح القرض المطلوب.
وأساسا هل من رئيس اليوم مثل الرئيس فؤاد شهاب الذي أنشأ مصرف لبنان ودشّن بناءه ووضع قانون النقد والتسليف؟! فضلا عن قوانين التعليم العالي والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها…
بالاستناد الى الأدبيات يؤكد بينسي-كوير وبيزاني-فيري [Benassy – Quere et Pisani- Ferry] من خلال دراسة تطبيقية تراجع مؤشرات استقلالية البنك المركزي على التوازن الأساسي على وجود تأثير إيجابي لاستقلال البنك المركزي على الانزلاقات في الموازنة العامة، وكلما كان البنك المركزي أكثر استقلالية، زاد الانضباط المالية العامة.
ويوضح سارجنت ووالاس [ٍ Sargent et Wallace] أن استقلال البنك المركزي يعني التخلي عن تسييل الدين العام وبالتالي يحظر اتباع سياسة غير مستدامة تؤدي في النهاية إلى الاختيار بين تسييل الدين والتخلف عن السداد. وفقًا لروغوف [ٌRogoff] ، فإن الأمر يتعلق بتعيين حاكم محافظ على رأس البنك المركزي ، وبالتالي يكون لديه حساسية عالية للتضخم ، أكثر بكثير من المتوسط بالنسبة للمجتمع ، في حين أن الاقتصادي “والش” [ٍWalsh] يثبت بدراسته أنه سيكون من الضروري طرح عقد تحفيزي يربط راتب حاكم البنك المركزي بتحقيق هدف سياسته النقدية!
ومن أبرز المؤشرات العلمية التي تخص حاكمية المصرف المركزي والتي تعتبر أساسية ليتمسّك بإستقلالية السياسة النقدية هو من ناحية شخصية الحاكم المتنزّه عن المصالح الشخصية والحامل مشروع نقدي واضح ورؤيا لنظام سعر الصرف مصوّبة نحو المصلحة العامة للإقتصاد والمجتمع بعيدا عن إسترضاء السلطات السياسية وتمويل العجوزات المالية والدين العام بغية إعادة تجديد لولايته.. ومن ناحية موازية المساعدة على تحقيق ذلك من خلال إدؤاج مواد قانونية تمنع التجديد لولايات متتالية أو مثلا تمنع التجديد لأكثر من مرة واحدة إذا اضطر الأمر. كما تؤكد الأدبيات الأاقتصادية على أهمية إطالة ولاية الحاكم أكثر من معدّل عمر الحكومات أو مؤسسات السلطة السياسية والحرص على عدم تزامنها لتفادي كليا التأير بينها…
أما في لبنان، يُعيًن الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم. كما أن المادة 113 تنص على أنه يتألف الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والاعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات. يقيد 50% من هذا الربح الصافي في حساب المصرف المركزي يدعى “الاحتياط العام” ويدفع 50% الى الخزينة. عندما يبلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف يوزع الربح الصافي بنسبة 20 % للاحتياط العام و80 % للخزينة.
منذ سنوات لعب مصرف لبنان دور محرّك الوساطة بين القطاع المصرفي والدولة فانغمست المصارف في توظيف الودائع لديها بين شراء سندات الدولة وشهادات ايداع المصرف المركزي مقابل فروقات خيالية بمعدلات الفوائد في محاولة تأخير انفجار الأزمة في غياب أي رؤيا اقتصادية فعلية والالتزام بتنفيذ أي من الاصلاحات التي تعهّد بها لبنان مراراً، خصوصاً في المؤتمرات الدولية المانحة للبنان الى ان أصبح المصرف المركزي منذ انفجار الأزمة شبه اللاعب الوحيد في غياب أي سياسة إقتصادية واضحة للتعامل معها، حتى أنه منذ إعلان وقف سداد الدين في آذار 2020 لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي لضبط وتخفيف انحدار الاقتصاد قبل البحث في إعادة نهوضه… فأصبحت السلطة النقدية مصدر القرارات الوحيد عبر سلسلة التعاميم.
قد جهدت السياسات الحديثة غير التقليدية في تثبيت إمكانية تحقيق صدقية المصرف المركزي من خلال سياسة المعايير الإسترشادية القائمة على إعطاء الجمهور علماً مسبقاً بمخططات السلطة النقدية لجهة تنامي Forward Guidance الكتلة النقدية ومستوى الفوائد واتجاه سعر الصرف بما يساعد العملاء الاقتصاديين على صوغ توقعاتهم بنحو صحيح، خلافاً لأسلوب المفاجأة والكتمان الذي كانت بعض المصارف المركزية تعتمده لإحداث فورة اقتصادية فجائية ولو بكلفة تضخّم باهظة مستقبلاً…
وقد استدعت دقة الأوضاع المالية سابقا التدخّل المستمر للمصرف المركزي لتمويل القطاع العام حتى أصبح أبرز المكتتبين في سندات الخزينة والتي دفعته مراراً للمشاركة في عمليات «السواب» والهندسات المالية مع المصارف التجارية، ما يعكس الشكل الثاني من السياسات النقدية غير التقليدية المعروفة بسياسات التليين النقدي الكمّي Quantitative Easing القائمة على ضخ السيولة لشراء السندات المالية من القطاعين العام والخاص والتليين النقدي النوعي، فضلاً عن الشكل الثالث للسياسات النقدية غير التقليدية القائمة على الشراء الكثيف للسندات على رغم ارتفاع درجة مخاطرها Qualitative Easing.
إلا أن السياسات الحديثة غير التقليدية واجهت عوائق عدة حدّت من فعاليتها ولا سيما من حيث انعكاساتها على المالية العامة وعدم تحفيز الدولة على ترشيد الانفاق العام وضبط الدين العام، خصوصا مع خفض الفوائد ومنها طبعاً على سندات الخزينة ما يسمح للدولة بالتراخي في ضبط المديونية طالما أنها غير مكلفة لناحية خدمة الدين العام، خصوصا بالعملات الأجنبية التي لا يطبعها المصرف المركزي بل يلجأ الى جذبها من المصارف عبر توظيف ودائع الناس لديها في شهادات الايداع بالدولار الأميركي كما حصل في لبنان، علماً أن قراءة استقلالية المصرف المركزي تتطلب النظر الى مستويين: المستوى النظري في النصوص القانونية كما على مستوى الممارسة الفعلية.
وإذا كان خيار العملاء الاقتصاديين في مرحلة ما هو «استيراد الصدقية النقدية» باللجوء إلى الدولرة، وكان اختيار مصرف لبنان هو السعي لتحقيق الاستقرار النقدي وفقا للنهج التقليدي النقدي من خلال التحكّم بالتضخم بالارتكاز على سياسة نقدية مقيّدة، قبل التحرك تدريجاً بنحو موازٍ لربط سعر الصرف في ظلّ معدلات دولرة آخذة في الارتفاع، بحثاً عن ضمان القدرة الشرائية للمدخرات وتسهيلاً للتسعير والتداول للمنتجات.. فالدولرة الجزئية لا بد من أن تقود الى خيار ثابت على المدى الطويل: إما الدولرة الشاملة أو الاستقرار النقدي الفعلي الذي يعيد الثقة بالعملة الوطنية على أساس صدقية السلطة النقدية والاستقلالية الفعلية للمصرف المركزي وخياراته في الحفاظ على القدرة الشرائية للمدّخرات…
اليوم قبل التجاذب بالأسماء بين المرشّحين لمنصب حاكمية مصرف لبنان والأطراف السياسية التي ينتمون إليها أو التي تطرح أسماءهم أو تؤيّدهم، السؤال الرئيسي: ما هي خلفيتهم الإقتصادية والسياسة النقدية التي يطرحونها؟ ما هو موقفهم من مبدأ إستقلالية المصرف المركزي وآاليات ومدى الدفاع عنها إزاء ضغوط تمويل المالية العامة على ضوء التجارب السابقة؟ وما هو نظام سعر الصرف الجديد الذي يحملونها كبديل عن نظام الربط المرن لسعر الصرف الذي سقط منذ نهاية 2019 ولم يتم إطلاق نقاش رسمي حتى اليوم عن كل من تكاليف ونتائج البدائل الممكنة لها حتى اتجه السوق نحو الدولرة الشاملة ولو بشكل غير رسمي بغياب أي قرار بهذا الأتجاه أو أي اتجاه آخر؟
اقتصاد
تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

قرر البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.
وأعلن المركز الوطني لتمويل “الإنتربنك”، وهي منصة إلكترونية رئيسية للسوق المالية في الصين تابعة لبنك الشعب الصيني، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5%.
وتعكس أسعار الفائدة الأولية مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.
ورغم تثبيت أسعار الفائدة على القروض الأولية منذ يونيو الماضي، فإن أسعار الفائدة على القروض الجديدة مازالت تتأرجح عند مستويات منخفضة.
وتظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة للشركات في الصين استقر عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 3 نقاط أساس عن العام الماضي.
وكان مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني قد أكد في وقت سابق من الشهر الحالي أن الصين ستحافظ على سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية مرنة بشكل معتدل خلال العام المقبل.
اقتصاد
البيت الأبيض يكشف عن الأموال التي حصلتها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية

أعلن البيت الأبيض أن الخزانة الأمريكية حصّلت 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الجاري.
وجاء هذا الإعلان من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة عيد الميلاد على قناته الرسمية في “يوتيوب”، حيث عرضت قائمة بـ”انتصارات ماجا 2025” بشكل متكرر مع موسيقى “لو-فاي” في الخلفية.
وتعد قيمة إيرادات الجمارك المعلنة في البث المباشر أعلى قليلا من المبلغ الذي ذكرته إدارة ترامب سابقا.
وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيرادات الجمارك التي تم تحصيلها بين تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي و15 ديسمبر الجاري بلغت ما يزيد قليلا عن 200 مليار دولار.
ومع ذلك، يظل المجموع أقل من التوقعات، حيث كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد توقع في يوليو الماضي الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام.
وتقوم المحكمة العليا الأمريكية حاليا بمراجعة قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وبعد توليه منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية على السلع من دول متعددة، متذرعا بمخاوف تتعلق بالمخدرات مثل الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري.
ولم يتضح بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا، وإذا حكمت ضد ترامب، فقد يضع ذلك الاتفاقيات التجارية القائمة موضع تساؤل.
اقتصاد
الصين توجه صفعة قوية للاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين اعتزامها فرض رسوم إغراق أولية تصل إلى 42.7% على وارداتها من بعض منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء (23 ديسمبر 2025).
وكانت الصين قد بدأت تحقيقا بشأن احتمال وجود إغراق من منتجات الألبان الأوروبية، في أعقاب تحقيقات في واردات لحم الخنزير وردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.
وستؤثر الرسوم الصينية الجديدة بشكل أساسي على دول مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا.
-

 خاص10 months ago
خاص10 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
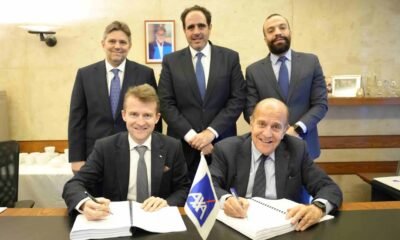
 مجتمع11 months ago
مجتمع11 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-

 Uncategorized1 year ago
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-

 مجتمع4 months ago
مجتمع4 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-

 قطاع عام1 year ago
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-

 محليات11 months ago
محليات11 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-

 أخبار عامة11 months ago
أخبار عامة11 months agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-

 مال1 year ago
مال1 year agoاتحاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت يطلق برنامج بطاقة مسبقة الدفع الخاص بالجامعة وذلك بالتعاون مع شركة فيزا



















